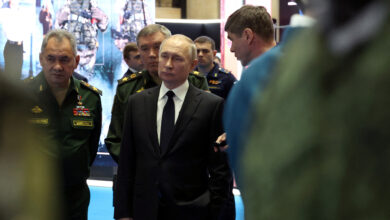يبدو أن ترامب المولع في صباه بمراهنات حلبات المصارعة الأمريكية الحُرّة والدموية قد حنّ في شيخوخته إلى كارِهِ القديم، معتبراً السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض حلبة من تلك الحلبات المثيرة التي لا حدود ولا ضوابط لها، مستثمراً “شرمة أُذُن” ـ إن ثبت صحّتها ـ كيفما يكون الاستثمار، لتوجيه الضربة القاضية لخصمه العجوز الخَرِف بايدن، وقبل أن يبدأ النِّزال الانتخابي الذي يتوقّع له أن يكون فريداً ومشوِّقاً وغير مسبوق، وبلا حدود أو ضوابط كذلك. لقد شاهد مئات الملايين، وربّما المليارات، حول العالم ما حدث، فاعتبره البعض مسرحية ركيكة السيناريو والإخراج وحتى أداء الممثّلين، فيما اعتبره آخرون فيلماً هوليوديّاً ضعيفاً لم يُتقن بطله لعب دور “رامبو” الذي يفتك بالجميع في سبيل بلوغ “الحلم الأمريكي”. في حين اعتبر فريق ثالث أن ما جرى حقيقيّ لا يساوره الشك أو يرقى إليه التشكيك، وأنّه يُصوّر الواقع المُزري الذي آلت إليه الولايات المتّحدة الأمريكية، ويعكس درجة الاستقطاب المريع المنفلت من عقاله، والذي يبيح استخدام كلّ ما هو متاح لدى العجوزيْن المتنافسيْن “المهووس” وَ“الخَرِف” في حلبة النِّزال الانتخابي الحامي الوطيس، بما في ذلك الضرب في الرأس وتحت الحزام.
وممّا يسترعي الانتباه مجريات وملابسات ما وقع بكونه عملية اغتيال فاشلة، خرج منها البطل المستهدَف ترامب منتشياً وملوّحاً بقبضة الانتصار يعلوه العلم الأمريكي وكأنّ شيئاً لم يكن، فيما خرج القنّاص جثة هامدة تُدفَن معها الكثير من الأسرار التي ستجعل من التحقيقات مجرّد لزوم ما لا يلزم، شأنها في ذلك شأن تحقيقات أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التي مضى عليها ما يقارب 23 سنة، واستُغلّت أبشع استغلال في التاريخ البشري قديمه وحديثه، حيث امتطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بجمهوريّيها وديمقراطيّيها صهوتها، لتشهرسيف “الحرب على الإرهاب” أو بالأحرى “الحرب على الإسلام”، وتُجيّش جيوش الغرب الاستعماري إياه، بل وتُبدع في إنشاء تحالفات دولية وإقليمية، واختلاق تنظيمات إرهابية حقيقية تحمل رايات “إسلامية” مزعومة ـ “الإسلام الأمريكي الخاص” المنشود ـ تأتمر بأمرها وتخوض حروبها القذرة التي لا تريد “تلويث” أياديها الملطخة بالدماء أصلاً، أو “تلطيخ” سمعتها الملطّخة لدى كافة شعوب الأرض منذ تأسيسها ثم تتويجها قائداً للغرب الاستعماري في أعقاب الحرب العالمية الثانية. تلك “الحرب على الإرهاب” المتواصلة التي أزهقت حياة الملايين من الأبرياء وعشرات الملايين من الجرحى والمعاقين واللاجئين والمشرّدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم من شتى الأعراق والجنسيّات، ناهيك عمّا ألحقته من تدمير بلدان وحضارات كانت مستقرّة وادِعَة، بدءاً من أفغانستان مروراً بالعراق وسوريا وليبيا والسودان.. والحبل على الجرّار. لا لشيء اقترفته تلك الدول والشعوب، وإنّما في سبيل تحقيق “الحلم الأمريكي” لتكريس الأحادية القطبيّة، وتحويل القرن الحادي والعشرين إلى قرنٍ أمريكيٍّ صَرْف، وهو ما اعترفت به كافة التسريبات والتصريحات الأمريكية ذاتها.
والجدير بالذكر، والشيء بالشيء يُذكر، أن مصير التحقيقات في “حادثة” اغتيال ترامب الفاشلة، لن يختلف عن مصير تحقيقات “أحداث 11 سبتمبر”.ولا مصير تحقيقات جريمة اغتيال الرئيس “جون كينيدي” في مطلع ستينيّات القرن العشرين الماضي، وتحديداً يوم 22/11/1963، في أحد شوارع دالاس بولاية تكساس، ومات قاتله بعد يوميْن من ارتكاب جريمته بإطلاق النار عليه أثناء نقله إلى السجن.. حيث ستُطوى كما طُويت سابقاتها داخل الأرشيف السرّي الممتليء قذارة وحقارة، وتُختم بالشمع الدموي الأحمر.. فالمهم هو استثمار الفعل وليس الفعل بحدّ ذاته، وتسليط الأضواء على الفاعل الحقيقي أو الفاعل المُختلَق لتصنيف الفعل جُرماً أم إرهاباً، حيث الغاية تبرّر الوسيلة وفق منطق ميكيافيللي السائد في الغرب الاستعماري.