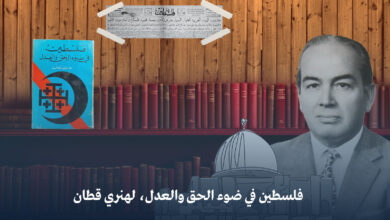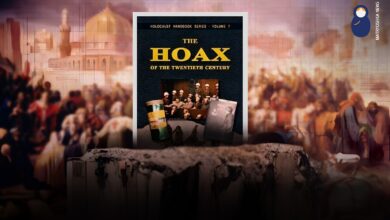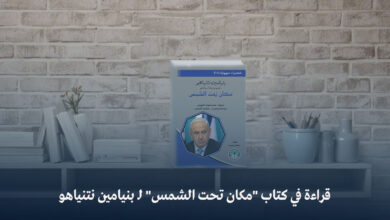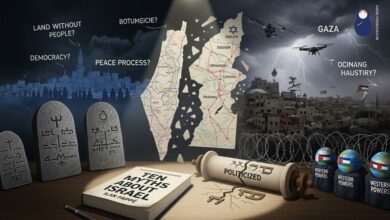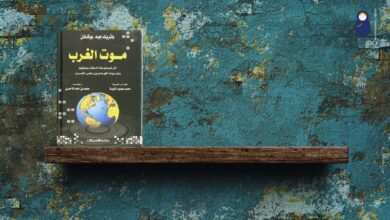قراءة في كتاب “هزيمة الغرب”
بعد كتابه الشهير “السقوط النهائي” الذي أصدره عام 1976، وهو ابن 25 عاماً، وتوقّع فيه انهيار الاتحاد السوفياتي، انطلاقاً من نظريته في “أنساق القرابة الأسرية” وإحصائيات معدلات وفيات الأطفال الرّضّع ـ وقتذاك ـ في الاتحاد السوفياتي.. عاود المؤرخ والانثروبولوجي وعالم الاجتماع والمحلل السياسي اليهودي الفرنسي إيمانويل تود، وبعد أكثر من ربع قرن، فأصدر كتابه المثير للجدل “ما بعد الإمبراطورية” عام 2001، قدّم فيه حججه على أفول الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية مهيمنة وتفكك النظام الأمريكي، رغم مزاعم انتصارها الكبير بانهيار الاتحاد السوفياتي.. وها هو يصدر العام الماضي 2024 كتابه الجديد “هزيمة الغرب” مثيراً فور إصداره جدلاً واسعاً ومتشعّباً، مستنداً فيه على خلاصة قراءاته للنظام الدولي الجديد في ضوء حرب أوكرانيا المستمرة، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه العجالة…
يركز تود على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سقوط الغرب، ومنها:
ـ نهاية الدولة القومية في الغرب.
ـ تراجع التصنيع، مما يفسر عجز حلف شمال الأطلسي عن إنتاج الأسلحة الضرورية لأوكرانيا.
ـ وصول المصفوفة الدينية الغربية – البروتستانتية – إلى “درجة الصفر” والإفلاس، والزيادة الحادة في معدلات الوفيات في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه في روسيا.
ـ تفاقم أعداد حالات الانتحار وجرائم القتل، وسيادة العدمية الإمبراطورية التي يعبر عنها هوس مزمن بالحروب الأبدية.
الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية
إذا كان كارل ماركس هو فيلسوف الاشتراكية الأول، فإن عالم الاجتماع وأستاذ القانون والمفكر الألماني ماكس فيبر هو فيلسوف الرأسمالية و”عرابها” بلا منازع، إذ رصد فيبر الظاهرة الرأسمالية وتطورها في العالم البروتستانتي، خاصة الولايات المتحدة، ووجد ارتباطاً وثيقاً بين منظومة الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ونشوئها وتطورها. حيث تبنت البروتستانتية أخلاق الانضباط والالتزام بالعمل وخفض الاستهلاك والادخار وتأجيل المتعة أو “التقوى الحضرية” بتعبير فيبر، لتكوين الرأسمال وإعادة استثمار عائد الإنتاج وتوسعه، وهذا بدوره له صلة وثيقة بروح الرأسمالية المبكرة، خاصة في مجتمعات الاستيطان الأوروبي الكبرى. فهذه المجتمعات قد هاجرت واستوطنت المستعمرات بفعل الاضطهاد الديني والمجاعات التي ضربت أوروبا في عصر الاكتشافات الجغرافية والمرحلة التجارية. لكن أزمة الرأسمالية المزمنة – خاصة النيوليبرالية الأميركية الراهنة التي تم تعميمها عالمياً – لا تقوم على الانضباط الاستهلاكي، بل على تعظيم الاستهلاك وإتاحة الاقتراض للأفراد والشركات والحكومات بشكل مفرط، فأصبح الاستهلاك يفوق الدخل، وغدا المستهلك ينفق ما لم يكسبه بعد، مما قلص المدخرات، وأدى إلى الغرق في بحار من الديون تجاوزت كثيرا الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تبخرت البروتستانتية وأخلاقها وآليات عملها التاريخية التي أدت إلى صعود العالم الأنغلو – أميركي…
انهيار البروتستانتية
يعزو تود الانحدار الغربي إلى “تبخر” قيم البروتستانتية، مسلطاً الضوء على “قيم العمل والانضباط الاجتماعي” المتأصلة في هذا الفرع المسيحي، والتي اعتبرها عنصراً أساسياً في صعود “العالم الأنغلو-أميركي”. واعتبر “أن تبخر البروتستانتية في أميركا وبريطانيا والعالم البروتستانتي قد تسبب في اختفاء ما يشكل قوة الغرب وخصوصيته، وأن المتغير المركزي هو الديناميات الدينية”. وهذا الانهيار التدريجي الداخلي للثقافة البيضاء الأنغلوسكسونية البروتستانتية أدى منذ الستينيات إلى “إمبراطورية محرومة من مركز ومشروع ومعنى، أي أنها كائن عسكري في الأساس تديره مجموعة بلا ثقافة (بالمعنى الأنثروبولوجي)”، هكذا يعرّف تود المحافظين الجدد في أميركا، ويصل إلى جوهر حجته في إعادة تفسيره لما بعد ماكس فيبر للأخلاق البروتستانتية وعلاقتها بروح الرأسمالية، فكتاب فيبر “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” -الذي نشر منذ أكثر من قرن (1904-1905)- جاء في وقت “كانت البروتستانتية هي مصفوفة صعود الغرب البروتستانتي، فموت البروتستانتية اليوم هو سبب التفكك والهزيمة”.
“ركائز الغرب“
يحدد تود بوضوح كيف كانت “الثورة المجيدة” الإنجليزية عام 1688 وإعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 والثورة الفرنسية عام 1789 الركائز الحقيقية للغرب الليبرالي، وبالتالي فإن “الغرب” الموسع ليس “ليبرالياً” تاريخياً، لأنه هندس أيضاً “الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية والنزعة العسكرية اليابانية”. ويبرز تود كيف فرضت البروتستانتية معرفة القراءة والكتابة الشاملة على السكان الذين تسيطر عليهم “لأنه يجب على جميع المؤمنين الوصول مباشرة إلى الكتاب المقدس، السكان المتعلمون قادرون على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، لقد صاغ الدين البروتستانتي بالصدفة قوة عاملة متفوقة وفعالة”، وبهذا المعنى كانت ألمانيا “في قلب التنمية الغربية” حتى لو حدثت الثورة الصناعية في إنجلترا. وقد وجد تود أوجه تشابه بين التاريخ الثقافي للبلاد وتاريخ الغرب البروتستانتي، وقال “إن المشترك بين البروتستانتية والشيوعية هو الهوس بالتعليم”، مضيفاً “لقد طورت الشيوعية -التي تأسست في أوروبا الشرقية – طبقات وسطى جديدة”، حيث العامل الحاسم في صعود الغرب هو ارتباط البروتستانتية بالأبجدية، بحسب تود. وعلاوة على ذلك، يؤكد تود أن البروتستانتية تقع مرتين في قلب تاريخ الغرب: من خلال الدافع التعليمي والاقتصادي، مع الخوف من اللعنة الإلهية والسعي نحو الخلاص والحاجة للشعور بالاصطفاء الإلهي، مما يولّد أخلاقيات عمل منضبطة وأخلاقية جماعية قوية، ومن خلال فكرة أن البشر غير متساوين (عبء الرجل الأبيض)، ولم يكن لانهيار البروتستانتية إلا أن يدمر أخلاقيات العمل لصالح الجشع الجماعي، أي النيوليبرالية (الجديدة).
التحول الجنسي
يبدو نقد تود الحاد لروح الثورة الطلابية في فرنسا عام 1968 مستحقاً لكتاب جديد كلياً، فهو يشير إلى أن “أحد الأوهام الكبرى في الستينيات والمشتركة بين الثورة الجنسية الأنغلو-أميركية وثورة مايو/أيار 1968 الطلابية في فرنسا الاعتقاد بأن الفرد سيكون أعظم إذا تحرر من الجماعة”. وقد أدى ذلك إلى كارثة حتمية، بحسب تود الذي يقول “الآن بعد أن تحررنا بشكل جماعي من المعتقدات الميتافيزيقية، التأسيسية والمشتقة، الشيوعية أو الاشتراكية أو القومية فإننا نعيش تجربة الفراغ”، ويكمل “هكذا أصبحنا عدداً كبيراً من الأقزام المقلدين الذين لا يجرؤون على التفكير بمفردهم، لكنهم يظهرون أنهم قادرون على التعصب مثل المؤمنين في العصور القديمة”.
إن تحليل تود الموجز للمعنى الأعمق للتحول الجنسي يحطم تماماً الحملات الداعية إلى حرية التحول الجنسي، من أميركا إلى أوروبا، وسيثير نوبات غضب متسلسلة، إذ يرى أن التحول الجنسي هو “إحدى رايات هذه العدمية المحددة للغرب الآن، وهذا الدافع لتدمير ليس الأشياء والبشر فحسب، بل الواقع أيضاً”. إذ “تقول أيديولوجية التحول الجنسي إن الرجل قد يصبح امرأة، والمرأة قد تصبح رجلاً، وهذا تأكيد كاذب، وبهذا المعنى قريب من القلب النظري للعدمية الغربية”، ويزداد الأمر سوءا عندما يتعلق الأمر بالتداعيات الجيوسياسية، حيث أن هوس الولايات المتحدة – منذ التسعينيات- بقطع ألمانيا عن روسيا سيؤدي إلى الفشل، ويقول “عاجلاً أم آجلاً سوف تتعاونان حيث إن “تخصصاتهما الاقتصادية تحدد أنهما متكاملتان”، ويقول إن الهزيمة في أوكرانيا سوف تفتح الطريق لذلك، حيث تعمل “قوة الجاذبية” على إغواء ألمانيا وروسيا بشكل متبادل. وعلى عكس أي “محلل” غربي تقريباً في محيط بلدان حلف الناتو يرى تود أن موسكو في طريقها للفوز على حلف شمال الأطلسي بأكمله، وليس فقط أوكرانيا، مستفيدة من نافذة الفرصة التي حددها بوتين أوائل 2022. ويراهن تود على نافذة زمنية مدتها 5 سنوات، أي أن نهاية اللعبة ستكون عام 2027 كما يقول.
الغرب الصفري
صفر دين، صفر أخلاق، صفر ذكاء، صفر كاثوليكية، صفر بروتستانتية، صفر يهودية، وصفر دولة قومية، صفر ذاكرة. يكثر إيمانويل تود من هذه المفردات التي يستعملها كل مرة في نهاية تحليله لمظاهر حياة الغرب وتطور ممارسته الثقافية والقومية والسياسية. ينبغي أن نذكر هنا أن تعريف الغرب يطرح إشكالًا ما، وأن إيمانويل تود حسمه بطريقة مترددة. لنقل إن الغرب بالنسبة للكاتب ليس كل ما يقع غربًا، وبالتالي فإنه غرب سياسي وثقافي وليس غربًا جغرافيًا. تخرج إيطاليا وإسبانيا مثلًا عن غرب تود، كما تخرج منه كل دول جنوب أوروبا وكذلك شمالها. الغرب الذي يتحدث عنه تود طيلة كتابه ويحلل أداءه وتطوراته وصراعاته، هو غرب أنجلوسكسوني بالأساس، بروتستانتي دينيًا، لكن دون حضور فاعل اليوم للبروتستانتية التي يقول إنها ماتت: الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا. أما ألمانيا وكذلك فرنسا خارجتان عن هذا الغرب، الأولى لاعتبارات أنثروبولوجية برغم بروتستانتيتها الأصلية (نموذج العائلة)، والثانية بسبب تبعيتها وعدم مشاركتها في القرار. أنثروبولوجيا يجد تود تقارباً شديداً بين كل من روسيا وألمانيا، بل يعتبر أن أحد أهداف حرب أوكرانيا الأساسية، وأهداف الأميركيين منها بصفة خاصة، هي منع التقارب الروسي الألماني، وبالتالي منع تشكل الفضاء الأوراسي. استراتيجياً، يصر تود على أن القطبين الروسي والألماني سيجدان طريقة ما للتقارب بعد أن تكون روسيا قد حسمت حرب أوكرانيا لصالحها، لأن المصلحة الإستراتيجية للبلدين تقتضي ذلك.
تؤدي العولمة، في مرحلتها النهائية الراهنة، إلى موت الدولة القومية، باعتبار أن السوق القومي هو أهم ما ميز تاريخياً تلك الدولة. شيئاً فشيئاً تقبل الدول القومية سابقاً بالخضوع لقوانين سوق معولم صيغت في مستويات أعلى من سياداتها القطرية، بل ولا تخدم بالضرورة بورجوازياتها المحلية. من الطبيعي أن ينشأ عن ذلك وضع يؤثر على سيادة هذه الدول فيما يخص القضايا الدولية. بالنسبة للولايات المتحدة، أصبحت أوروبا مجرد كيانات تابعة تلعب دوراً شبيها بما لعبته دول أميركا الجنوبية تاريخياً، تخضع للتهديد بعقوبات تجارية فتحذو حذوها حتى في الصراعات التي ليس من مصلحة أوروبا أن تنفجر أصلاً. عادةً ما يقع تقديم الغرب كمنبع للثقافة الديمقراطية، ونحن نجد اللحظتين المؤسستين لهذا الانطباع في الاستقلال الأمريكي وكذلك في الثورة الفرنسية. غير أنه في حين لا يزال يقع النظر لروسيا، أو الدعاية ضدها، باعتماد الصورتين القيصرية والستالينية، فإنه لا أحد في الغرب يريد تذكر أن النازية والفاشية كانتا من أبناء الثقافة الديمقراطية الغربية.
انهيار الأسرة والانحلال الأخلاقي والديني
يعتمد تود على الإحصائيات الأخلاقية، ويقصد بها إحصائيات الجرائم، للقول بأن الأرقام تؤكد معاناة الغرب من أزمة أخلاقية عنيفة، في حين أن نفس الأرقام توحي بتراجع التوترات الاجتماعية في روسيا. يرى الكاتب أن العائلة في أوروبا انتهت رسميًا بتقنين الزواج المثلي، حيث يؤدي هذا التقنين حتما لانهيار القيم الأخلاقية التي تغذي بها الأسرة التقليدية المجتمع. لذلك أسباب أعمق من صدور النصوص القانونية المثلية، وأهمها انهيار الروابط الدينية في المجتمعات الغربية. للبروتستانتية دور تاريخي هام في نشأة الدول القومية من خلال الدور الذي لعبته في تفجير سيادة الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا، وتحطيم النظام الإقطاعي، ونشأة البورجوازيات، وبالتالي السوق القومية والمنظومة الرأسمالية. يتتبع تود تراجع الممارسات الطقوسية ذات الأصول الدينية للتأكيد بأن الغرب يعيش اليوم حالة الصفرية الدينية: ليس الزواج المثلي فقط، وإنما المشاركة في الأعياد الدينية وتراجع الدفن لصالح حرق الرفات ونهاية التعميد. تؤثر نهاية الدين على علاقة الناس بالعمل وبالقومية وعلى نظرتهم للمال وللفن، وتحدد درجة توتر العلاقات داخل المجتمع. تنتصر الفردانية وقيم الربح السريع، ويتحول الإنسان من كائن اجتماعي منظم في أطر فوق ربحية، إلى مجرد فرد مستهلك للعولمة وغير محمي إزاءها بأي من الهياكل التي كانت تقف بينه وبين السوق في عصر الدول القومية. يبدو تفكيك الروابط الاجتماعية أمرًا لازمًا للعولمة، وكذلك تفتيت حضور الدين في المجتمع، لأن الهدف هو الحصول على مجرد مستهلكين لا تضامن من أي نوع بينهم. حيث تم الوصول إلى هذه المرحلة في نظر الكاتب في سنة 2000 عندما تم فرض الزواج المدني. لقد كان ذلك أهم مظهر من مظاهر موت المسيحية في الغرب الذي زادت في تأكيده قوانين “الزواج للجميع”. الاحتفاء بوصول مثليين لمواقع القرار الأولى في الدول الأوروبية هو ترسيخ لانهيار الأخلاق الدينية، ومحاولة تقديم المثلية كنمط اجتماعي وثقافي جديد لتغطية الفراغ الذي تركه انهيار الدين. النيوليبرالية، حسب نظر الكاتب، هي مجرد نظام ربح بلا أخلاق تنظم المجتمع. من خلال النيوليبرالية، أفقدت العولمة المجتمعات تماسكها وقدرتها على بناء إيديولوجيات بديلة وحمائية، وعلى معاملة المجتمع ككتلة متضامنة وبالتالي التشريع لها على هذا الأساس.
انعدام القيم الأخلاقية وانتصار الربح كقيمة وحيدة، مع ما يتبع ذلك من ممارسات ثقافية وتشريعية شاذة، لا تؤدي إلا إلى العدمية التي أصبحت ثقافة النموذج النيوليبرالي. اقتصاديًا، دمرت النيوليبرالية قيمة العمل نفسها، وانتصر نموذج الربح السريع بغض النظر عن صدوره عن أي قيمة إنتاجية. يفسر إيمانويل تود بعضًا من ذلك عبر الاستشهاد بالإحصائيات التعليمية، حيث يلاحظ انهيار دراسات الهندسة في الغرب، وانفجار أعداد المرسمين في اختصاصات التجارة من بنوك وبورصة وغيرها. يمكن أن نجد في ذلك تفسيرًا في عجز الغربيين عن إنتاج ما يحتاجه الأوكرانيون من ذخائر المدفعية مثلاً.
على العكس من ذلك تماماً، نجد أن دولاً مثل روسيا وإيران والهند والصين تسير في اتجاه تدعيم الشعب التعليمية الهندسية، ما يجعلها قوى المستقبل اقتصادياً وتقنياً. بالنسبة للدول الغربية، يقدم تود دلائل على أن جانباً هاماً من المرسمين في الدراسات الهندسية والمشتغلين فيها هم في الحقيقة أجانب أو ذوي جذور أجنبية. التقنية من هذا المنطلق أداة فعالة في صناعة الشعور القومي باعتبارها تؤدي إلى تحقيق الاستقلالية التقنية. انعكاسات فقدان السيادة على التقنية لا تقل عن انعكاسات تراجع الممارسات الدينية أو زيادة المعدلات السنوية للجرائم. دون أن يسميها مباشرةً، فإن الكاتب يقودنا إلى اعتبار أن الشعبوية التي تتصاعد في عالم اليوم، ليست إلا ردة فعل على عدمية النموذج النيوليبرالي للعولمة. أدت هذه الأخيرة إلى تدمير الأسس التقليدية للمجتمعات الغربية، من طبقات وثقافة ذات جذور دينية، وعائلة، وقيم. عدمية أو صفرية حضارية لا تمس فقط من عالم القيم، وإنما تنعكس ضرورة ومباشرة على الأسس المادية للدولة القومية، مثل التقنية والسوق، وبالتالي الشعور القومي والقدرة على تمثيل المجتمع. لكنها أيضًا عدمية يرافقها تصاعد كبير للممارسات العنصرية وللعنف الذي لم يعد يعرف أي حدود من قبل إمبراطورية العالم الحالية، الولايات المتحدة الأميركية. تقود أميركا العالم اليوم نحو تعميق صفريته وبالتالي تفتته وتبعيته لها كممثلة لهذا العالم الصفري، ما يتسبب في مزيد من التوتر الدولي في مواجهة نماذج ثقافية واقتصادية وقومية أخرى، وتشن عليها الحروب الأعنف فالأعنف من أجل تدمير خصوصياتها التي تحميها من التفتت لصالح النيوليبرالية. هذه بعض الاستنتاجات من كتاب تود، والتي تؤدي لا لفهم طبيعة المعركة في أوكرانيا، بل في غزة أيضًا التي خصص لها المؤلف صفحات في نهاية الكتاب.
في روسيا، يقع إحياء الأرثوذكسية تحت إشراف الدولة ذاتها، حيث تلعب دورًا في تدعيم الحس القومي. نحن بإزاء كنيسة قومية تقاوم الانحلال الأخلاقي والعائلي الذي يرفعه الغرب اليوم كأحد أكبر نجاحاته. وهكذا، فبعد أن كان إلحاد النظام السوفيتي حاجزًا أمام إبداء المجتمعات المحافظة في فضاءات أخرى تعاطفا معه، فإن التحول الكبير الذي حدث منذ انهياره، والتقارب الذي حل محل النفور بين الدولة والدين، يمنح روسيا اليوم في العالم قوة معنوية غير متوقعة. يرفض إيمانويل تود الفكرة التي تقول إن المجتمعات الأبوية لا تعطي المرأة حقوقها. هي لا تعطيها الحقوق السائدة في المجتمع الليبرالي الغربي لأن الأمر لا يتعدى هنا حقوقًا ناجمة عن نظام اجتماعي معين، نسبي، وليس عن حقيقة أنثروبولوجية عامة. تجاه الدعاية المثلية، ترفع روسيا راية المحافظة الأخلاقية، ما بعد الدينية، وتحقق بذلك نجاحات لدى فئات واسعة في المجتمعات الغربية ذاتها بإحياء تخوفات هذه الفئات الدينية والأخلاقية.
“الغرب نحو حتفه: حدود الهيمنة وانحسار المعنى”
يستند تود إلى نهج متعدد التخصصات، جمع التاريخ والأنثروبولوجيا والاقتصاد، متوقعاً أن الغرب قد غادر قمة جبل العالم، وأخذ طريق المنحدر، ولا يتعلق توصيف تود لهزيمة الغرب بالجانب العسكري، مع أنه لا ينفيه تماماً فيما يجري على الجبهة الأوكرانية، وكذلك فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الدفاعية. الهزيمة هنا فكرية، تتمثل في فقدان الغرب سلاحه الأساسي الذي سيطر من خلاله على العالم على مدى خمسة عقود. يعتقد تود أن بذور الهزيمة ولدت في لحظة النصر، أي عند النشوة التي أصابت الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. لتظهر الهزيمة واضحةً بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا عام 2022. يبدأ تود تحليله من الحرب في أوكرانيا، من خلال طرح إشكالية: لماذا استهان الغرب بالخصم الروسي، وكيف قاد الوهم زعماء الغرب، بشقيه الأوروبي والأمريكي، إلى الاقتناع بنتائج مفترضة كانت جميع الأرقام تقف ضدها. كما يعتقد تود أن الغرب قد استقر مسيطراً حتى أصبح عاجزاً عن رؤية أي فرضية للتنوع في العالم خارج هيمنته، لذلك كان عاجزاً حتى عن قراءة الأرقام والتحليلات العلمية التي تنتجها مؤسساته. وعبر منهج إحصائي يمارس الكاتب خبرته في حشد طائفة واسعة من الأرقام للبرهنة على أن الخصم الروسي كان له من الاستقرار والاستعداد ما يكفي لدفع ثمن العملية العسكرية في أوكرانيا، عكس ما اعتقدت واشنطن وبروكسل. ويعتمد تود على “الإحصاءات الأخلاقية” لإثبات صلابة الجبهة الداخلية الروسية بين عامي 2000 و2017، وهي المرحلة المركزية لتحقيق الاستقرار في عهد فلاديمير بوتين، حيث انخفض معدل الوفيات الناجمة عن إدمان الكحول في روسيا من 25.6 لكل 100 ألف نسمة إلى 8.4 لكل 100 ألف نسمة. كما اخفض معدل الانتحار من 39.1 إلى 13.8، ومعدل القتل من 28.2 إلى 6.2. وهذا يعني، بالأرقام الأولية، أن الوفيات الناجمة عن إدمان الكحول انخفضت من 37214 وفاة سنويًا إلى 12276 وفاة، وحالات الانتحار من 56934 حالة إلى 20278 حالة، وجرائم القتل من 41090 جريمة إلى 9048 جريمة. أما معدل الوفيات السنوية بين الرضع، فقد انخفض من 19 لكل 1000 “طفل ولد حياً” في عام 2000 إلى 4.4 في عام 2020، وهو أقل من المعدل الأمريكي البالغ 5.4 (بحسب اليونيسيف). ومع ذلك، فإن هذا المؤشر الأخير، بقدر ما يتعلق بأضعف الناس في المجتمع، له أهمية خاصة لتقييم الحالة العامة للمجتمع. أما البيانات الاقتصادية لروسيا فتثبت الارتفاع السريع في مستوى المعيشة بين عامي 2000 و2010، وتلاه بين عامي 2010 و2020 تباطؤ ناجم عن الصعوبات الناجمة بشكل خاص عن العقوبات التي أعقبت ضم شبه جزيرة القرم. لكن الاتجاه الذي توضحه الإحصاءات الأخلاقية أكثر انتظامًا وعمقًا، ويعكس حالة من السلام الاجتماعي وإعادة اكتشاف الروس بعد كابوس التسعينيات، أن العيش المستقر أمر ممكن.
لكن هذه العناصر الموضوعية لم تمنع العديد من المنظمات غير الحكومية، وهي في أغلب الأحيان وكالات غير مباشرة تابعة للحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من الحط من شأن روسيا بشكل مستمر في تقييماتها، وهذا شكل جزءاً أساسياً من فخ الوهم الذي سقط فيه الغربيون. ويشير الكاتب إلى أن منظمة الشفافية الدولية، التي تصنف دول العالم الثالث حسب معدل الفساد فيها، عندما وضعت في عام 2021 الولايات المتحدة في المرتبة 27 وروسيا في المرتبة 136، وضعتنا أمام استحالة. فالدولة التي تتمتع بمعدل وفيات بين الرضع أقل من الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون، برأيه، أكثر فساداً منها. ذلك أن معدل وفيات الأطفال، يشكل في حد ذاته مؤشراً أفضل للفساد الحقيقي من هذه المؤشرات المصنعة وفقاً لمعايير لا أحد يعرفها. أما “الإحصاءات الاقتصادية”، فتؤكد أن فرضية الاقتصاد الحقيقي التي راهنت عليها موسكو كانت أحد دروعها الأساسية في الحرب. فقد نجحت روسيا، في غضون سنوات قليلة، ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بل في أن تصبح واحدة من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم. وصلت صادرات الأغذية الزراعية الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار، وهو رقم أعلى من عائدات صادرات الغاز الطبيعي في العام نفسه (26 مليار دولار). وهذه الديناميكية، التي كانت مدفوعة في البداية بالحبوب والبذور الزيتية، أصبحت الآن تعتمد أيضاً على صادرات اللحوم. كما سمح أداء القطاع الزراعي لروسيا بأن تصبح مصدراً صافياً للمنتجات الزراعية في عام 2020، وذلك لأول مرة في تاريخها الحديث: بين عامي 2013 و2020، وتضاعفت صادرات روسيا من الأغذية الزراعية ثلاث مرات، في حين انخفضت الواردات إلى النصف. أما استمرار وجود روسيا باعتبارها ثاني أكبر مصدر للتكنولوجيا النووية على مستوى العالم فهو أقل إثارة للدهشة. حيث كان لدى شركة روساتوم، الشركة الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع، في عام 2021، 35 مفاعلاً قيد الإنشاء في الخارج (لا سيما في الصين والهند وتركيا والمجر). ويبدو أن كل نظام من أنظمة العقوبات دفع روسيا إلى تنفيذ عمليات إعادة تحويل اقتصادية متسلسلة واستئناف استقلالها عن السوق الغربية. ولعل مثال إنتاج القمح هو الأكثر إثارة للإعجاب. في عام 2012، أنتجت روسيا 37 مليون طن من القمح، وفي عام 2022، أنتجت 80 مليون طن، أي أكثر من الضعف خلال عشر سنوات. تبدو هذه المرونة منطقية عند مقارنتها بالمرونة السلبية التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
العامل الثاني الذي يستند إليه تود لتحليل الوهم الغربي في مقاربة الخصم الروسي هو اعتقاد قطاع واسع من النخب الغربية السياسية والفكرية، بأن تنامي الطبقات الوسطى واتساع مجال التعليم العالي، سيجعل من بقاء نظام الرئيس بوتين محل تهديد. يستند هذا الوهم الغربي إلى فكرة التطابق بين الطبقات الوسطى في الغرب والطبقة الوسطى الروسية. وعن ذلك يذهب الكاتب إلى أن هذا التطابق، نابع من رغبة الغرب في تصور العالم غير الغربي على صورته. يعتقد تود أن مثل هذا التمثيل يتجاهل ما يميز الطبقات المتوسطة الروسية عن نظيراتها الغربية. إذا كانت الطبقات الوسطى الروسية بالتأكيد أكثر ليبرالية قليلًا من بقية السكان، فهي أبعد ما تكون عن التشابه الكامل مع الطبقات الوسطى الغربية، ويرتكز الاختلاف بينهما على خلفية أنثروبولوجية فريدة، والتي تشكل أيضاً أحد العناصر التي تفسر صلابة روسيا في مواجهة الغرب، وهي قيام الطبقة الوسطى على الأسرة لا الفرد.
كما أن ما جعل روسيا قوية، وما سمح لها بالحفاظ على سيادتها في نظام معولم، هو قدرتها العفوية على منع تطور الفردية المطلقة، فما زال في روسيا القدر الكافي من القيم المجتمعية لضمان بقاء نموذج الأمة المدمجة وعودة شكل معين من أشكال الوطنية إلى الظهور. حيث مازال النموذج العائلي المهيمن على التشكيل الاجتماعي الروسي قادرًا على إنتاج تصور روحي للدولة-الأمة، أي تصوراً للمصير الجماعي المشترك بين أفراد المجتمع. لا يحضر النموذج الروسي في الحرب الأوكرانية في كتاب إيمانويل تود إلا بوصفه شاهد خسارة للغرب، أي لوحةً يمكن من خلالها أن نقبض على مواطن الهزيمة مجسمةً في تفاصيل وأرقام وأوهام. لذلك كانت فصول المفتتح عن الحرب الجارية في أوروبا الشرقية مدخلًا لطرح أسباب هزيمة الغرب.
روسيا الراغبة في نصر كامل
اللافت في الكتاب الأخير للكاتب والباحث السوسيولوجي – الأنثروبولوجي الفرنسي إمانويل تود أنه يلخص في عنوانه «هزيمة الغرب» خلاصة 371 صفحة يقدمها للقارئ غنية بالأرقام والمعلومات والمراجع. نقطة انطلاقه حرب أوكرانيا التي تتيح له أن يعرض ويناقش الأسباب التي تجعله يجزم بأن روسيا هي التي ستخرج منتصرة من الحرب، وأن هزيمة أوكرانيا المحققة هي بالدرجة الأولى هزيمة للغرب وللولايات المتحدة. صحيح أنّ تود يبدو متسامحاً مع روسيا وبالغ التشدد مع الغرب، وصحيح أيضاً أنه يحمّل الأخير مسؤولية الحرب، بأن يذكّر مثلاً بتصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند اللذين أعلنا، كل واحد من جانبه، أن “اتفاقية مينسك” التي أنهت الحرب الأولى في أوكرانيا عام 2015 كان هدفها “توفير الوقت اللازم لتسليح كييف” بأسلحة غربية – أطلسية. ويستعيد الكاتب الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي بوتين في 24 فبراير (شباط) 2022؛ ليبرر حربه على أوكرانيا، وجاء فيها: “لا يمكن أن نقبل بتمدد قواعد الحلف الأطلسي واستخدام الأراضي الأوكرانية لهذا الغرض”، مضيفاً أن ثمة “خطوطاً حمراء تم تجاوزها”. لذا فالعمل العسكري الروسي هو “دفاع عن النفس”. ومنذ عامين، لم يحد بوتين عن هذه السردية، وكرّرها في مقابلة مطولة أجراها معه الصحافي الأميركي توكر كارلسون، المقرّب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في موسكو.
ويرى تود أن حرب أوكرانيا جاءت بعشر مفاجآت، أولها قيام الحرب في أوروبا نفسها التي نظرت إلى الحدث بصفته “غير معقول في قارة ظنت أنها تعيش سلاماً أبدياً”. وثانيها أنها وضعت روسيا والولايات المتحدة وجهاً لوجه، فيما كانت واشنطن تعد الصين عدوها الرئيسي وليس روسيا “المتهالكة”. أما المفاجأة الثالثة، ففي قدرة كييف على المقاومة بينما كان الغربيون يعتقدون أنها ستنهار خلال 72 ساعة، وأعدوا خططاً وسيناريوهات لإخراج الحكومة الأوكرانية وعلى رأسها فولوديمير زيلينسكي من كييف إلى الغرب. كذلك فاجأت أوكرانيا روسيا نفسها. ومع تمدد الحرب، جاءت المفاجأة الرابعة، وهي قدرة روسيا على مقاومة الضغوط الاقتصادية التي فرضت عليها منذ الأسبوع الأول للحرب، بما في ذلك عزلها عن النظام المالي الدولي. وخامس المفاجآت “انبطاح” الاتحاد الأوروبي، وغياب أي استقلالية عن الإرادة الأميركية. وما يصدم تود تحديداً تلاشي “محور باريس – برلين” الذي كان أساس البناء الأوروبي لصالح محور لندن – وارسو – كييف. ويوجّه الكاتب سهامه لبريطانيا التي تحولت إلى “كلب ينبح” بوجه روسيا ملتحقة بواشنطن. وسادس المفاجآت، انتقال عدوى الالتحاق بواشنطن وبالحلف الأطلسي إلى الدول الاسكندنافية التي “سارت على نهج مسالم” في السابق، وإذ بها تتحول إلى دول “مشاغبة”، بدليل انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي. وسابع المفاجآت عجز الصناعات الدفاعية الأميركية عن توفير الأسلحة والذخائر الكافية للقوات الأوكرانية. وبالمقابل، فإن روسيا ومعها حليفتها بيلاروسيا وهما لا يزنان سوى 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الغربي الخام، نجحتا في إنتاج أسلحة أكثر مما أنتجته المصانع الأميركية والأوروبية مجتمعة. أما ثامن المفاجآت فعنوانها “العزلة الآيديولوجية للغرب”، بحيث لم ينجح في جر العالم وراءه ووراء أوكرانيا، مشيراً إلى الصين والهند وبلدان “مجموعة البريكس”، وغالبية أميركا اللاتينية، وغالبية دول آسيا وأفريقيا. وكتب تود: “بعد عام ونصف العام على اندلاع الحرب، ينظر مجمل العالم الإسلامي إلى روسيا بوصفها شريكاً وليست عدواً”، والمفاجأة الأخيرة الآخذة بالبروز تتمثل في توقع حتمية هزيمة الغرب. ويستبق الكاتب الفرنسي منتقديه القائلين إن “الحرب لم تنته بعد”، بالرد: “هزيمة الغرب واقعة لا محالة؛ لأنه آخذ في تدمير نفسه أكثر مما هو ضحية لهجمات روسية”.
حلم الأميركيين بإطاحة بوتين لن يتحقق
يرجع الكاتب أحد أسباب قدرة روسيا على الصمود والمواجهة إلى كونها بدأت تستعد لمواجهة العقوبات منذ 2014. ولعل هذه العقوبات بالذات هي التي وفرت ثبات الاقتصاد الروسي، بدليل أن الصادرات الزراعية الروسية بلغت في عام 2020 (30 مليار دولار)، متخطية عائدات الغاز (26 مليار دولار). وتحولت روسيا إلى أول مصدر للمفاعلات النووية ذات الاستخدام السلمي، وإلى ثاني مصدر للأسلحة في العالم بفضل قفزات حققتها في التكنولوجيا الرقمية. ويتوقف الكاتب طويلاً عند قدرة الاقتصاد الروسي على “التأقلم” مع العقوبات من جهة، ومع التحول إلى “اقتصاد حرب”، وهو ما لم ينجح الغربيون في تحقيقه. ويأخذ على الغربيين رؤاهم الزائفة لروسيا التي “يحكمها ديكتاتور دموي (يذكر بستالين) ويسكنها شعب من السذج”. ولنقض هذه الصورة، يسرد الكاتب فيضاً من الأرقام، ومنها أن عدد المهندسين الروس يتفوق على عدد نظرائهم من الأميركيين، والأمر نفسه يصح على نسبة المتعلمين، وذلك بالتوازي مع بروز طبقة وسطى ناشطة ودينامية، وتمكن بوتين من الحد من قدرات “الأوليغاركيين” الروس. ويجزم تود بأن “نظام بوتين” المرشح لولاية إضافية “ثابت ومستقر وحلم الأميركيين بتمرد يطيح به لن يتحقق”. ويؤكد الكاتب أن تحدي روسيا للغرب قبل عامين مرده لكونهم “أصبحوا جاهزين عسكرياً”، ولأن ديموغرافيتهم تتراجع، فقد عجلوا في إطلاق الحرب، ويعتقدون أنهم “قادرون على الانتهاء منها خلال خمسة أعوام”. وبالمقابل، فإن النواقص الصناعية والعسكرية الغربية تظهر أكثر فأكثر للعيان، وعامل الزمن يلعب لصالح روسيا. ويحذر الكاتب الجانب الأميركي بالقول: “ما تريده روسيا هو الانتصار الكامل ولا شيء آخر”.
وصفحة بعد أخرى، يظهر أن الكاتب يتبنى إلى حد بعيد طروحات روسيا بخصوص أوكرانيا، التي وصفها بوتين مؤخراً بأنها “دولة مصطنعة أنشأتها إرادة ستالين في عام 1922″، نافياً عنها صفة “الأمة في دولة”. وحسبه هي في أفضل الأحوال “دولة فاشلة” تتجه نحو “العدمية”. فأوكرانيا “ينخرها الفساد”، وهي “تؤجر بطون نسائها” للغربيين من أجل الإنجاب، وتقضي على اللغة (الروسية) المتجذرة تاريخياً فيها، حيث إنها “تنتحر ثقافياً”. وما يراه تود غريباً أن منع اللغة الروسية استتبعه مشروع قانون يفرض على الموظفين إتقان الإنجليزية. ويجزم الكاتب بأن كييف كانت قادرة على تجنب الحرب منذ 2014 لو قبلت المطالب الروسية المعقولة الثلاثة وهي: ضم شبه جزيرة القرم لروسيا لأسباب تاريخية، ومنح سكان منطقة الدونباس (شرق أوكرانيا)، وهم من الروس، وضعاً مقبولاً، وأخيراً حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الأطلسي. ولكن كييف رفضت بتشجيع من الغرب ما قاد إلى الحرب.
انتحار أوروبا
ليست أوكرانيا وحدها التي تتجه إلى الانتحار بل معها أوروبا (ص 161). والحجة التي يسوقها تود أن الاتحاد الأوروبي الذي كان يسعى ليكون القوة الثالثة المستقلة بين الولايات المتحدة والصين “اختفى تماماً وراء الحلف الأطلسي الخاضع لأميركا”، وأن الدول الاسكندنافية والمشاطئة لبحر البلطيق “أصبحت تابعة مباشرة لواشنطن”. وبالتوازي، يؤكد الكاتب أن الحصار المفروض على روسيا “مدمر للاقتصادات الأوروبية”، ومن ذلك ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات والتضخم ما يهدد الصناعات الأوروبية “ويقودنا إلى مفهوم الانتحار”.
ولتثبيت نظريته، يؤكد تود أن الميزان التجاري الأوروبي تحول من فائض إيجابي قيمته 116 مليار يورو في 2021 إلى عجز يتجاوز 400 مليار يورو في 2022، ناهيك عن تكلفة باهظة للحرب. ويتساءل: “لماذا يريد الغربيون حرباً بلا نهاية” بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد صيف عام 2023؟ ومرة أخرى يتبنى تود السردية الروسية القائلة إن روسيا “تحارب على حدودها، بينما الجبهة تبعد 3200 كلم عن لندن و8400 كلم عن واشنطن”. وخلاصة الكاتب أن “المشروع الأوروبي (الأساسي) مات، وأن أوروبا تحتاج لعدو خارجي وجدته في روسيا”. وفي سياق انتقاداته يوجه سهامه إلى بريطانيا التي يصف ردود فعلها بـ”المضحكة”، وهي تحاول الإيحاء بأنها تعيش مرة أخرى “معركة إنجلترا” ضد الجيش الألماني، كما قارن وزارة الدفاع البريطانية بـ”أفلام جيمس بوند” وعدّ أن لندن هي الأكثر تطرفاً بالدفع نحو مواصلة الحرب.
“العصابة الحاكمة في واشنطن“
يُكرّس الكاتب الفصل العاشر في الكتاب وهو بعنوان “العصابة الحاكمة في واشنطن”، ليشرح بالأرقام أسباب قوة اليهود في السياسة الخارجية الأميركية. ومخافة اتهامه بمعاداة السامية وهي تهمة رائجة، يحرص الكاتب على تأكيد أنه يتحدر من عائلة يهودية من أصول مجرية. ويذكر تود أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعدته فيكتوريا نولاند من أصول يهودية، في حين أن الرئيس بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، كاثوليكيان من أصول آيرلندية، لافتاً إلى أن اليهود لا يشكلون سوى 1.7 في المائة من الشعب الأميركي (ص 288)، فيما تمثيلهم في المواقع الرسمية، وتحديداً المرتبطة بالسياسة الخارجية لا علاقة له بنسبتهم العددية. ويسيطر اليهود على مواقع القرار في المراكز البحثية، والمثال على ذلك أن ثلث أعضاء الهيئة الإدارية لـ”مجلس العلاقات الخارجية” من اليهود، كما أن ثلاثين في المائة من أصل أكبر مائة ثري في الولايات المتحدة هم أيضاً من اليهود. ولهؤلاء، كما هو معروف، تأثيرهم الكبير على الجامعات والمعاهد العليا على اعتبار أنهم من كبار المانحين، وهو ما ظهر جلياً مع حرب غزة. ويُفسر الكاتب أهمية اليهود بعاملين: الأول تراجع القيم البروتستانتية لدى المجموعة الحاكمة السابقة وهي (الأنغلو ساكسونيون – البيض البروتستانتيون ). والثاني تركيزهم على التعليم، وارتياد المعاهد والجامعات الأكثر تميزاً ما يؤهلهم لاحتلال أعلى المراكز.
ويحمل الفصل الأخير من كتاب تود عنوان “كيف وقع الأميركيون في الفخ الأوكراني؟”، وفيه يتساءل عن الأسباب التي تجعل أميركا “تدخل في حرب مع روسيا وهي عاجزة عن الانتصار فيها”. ويرى تود أن حرب أوكرانيا جاءت خاتمة لدورة زمنية بدأت في 1990 مع انهيار الاتحاد السوفياتي وقناعته أن تمازج عدميتين، أميركية وأوكرانية، سيقود إلى هزيمتهما (ص 339). فبينما كانت الولايات المتحدة غارقة في حروبها (أفغانستان، والعراق…) وكانت الصين تقضي على النسيج الصناعي الأميركي، كانت روسيا تعيد ترتيب أوراقها (ص 347). ومع وصول بوتين إلى السلطة، وجد أمامه بولندا والتشيك والمجر في حلف الأطلسي. وكانت واشنطن تدفع نحو انضمام أوكرانيا أيضاً. وفي 2004، انضمت سبع دول إضافية إلى الحلف، كانت كلها أعضاء في حلف وارسو، وهي: بلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا بحيث شعرت روسيا بالطوق الأميركي حول عنقها. وجاء رد بوتين في خطابه عام 2007، بمناسبة مؤتمر الأمن في ميونيخ واضحاً، حيث أكد أن بلاده “لن تقبل أبداً عالماً أحادي القطب تفرض فيه الولايات المتحدة القانون”. ويؤكد الكاتب أنه مع دعوة كييف للانضمام للحلف الأطلسي، خلال قمة بوخارست عام 2008، “نصبت واشنطن الفخ الذي لن تستطيع الإفلات منه (ص 354)”.
يستعيد تود السردية الروسية بتأكيده أن أوكرانيا كانت تخطط لهجوم نهاية عام 2021 لاستعادة الدونباس وشبه جزيرة القرم، ما دفع بوتين لمراسلة الحلف الأطلسي لطلب “ضمانات”، بيد أن هذه الضمانات لم تأت، وكانت النتيجة أن روسيا أطلقت حربها أواخر فبراير 2022 “في التوقيت الذي اختارته وبعد دراسة لميزان القوى، حيث وجدت أن هناك نافذة ما بين 2022 و2027”. إلا أن انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها شمال وشرق كييف، ثم الهجوم المضاد الذي قامت به خريف العام نفسه “أوجد دينامية دافعة باتجاه الحرب” في واشنطن، وتوجهاً “للمزايدة لن تستطيع التراجع عنها تحت طائل تلقيها هزيمة، ليس فقط محلية بل شاملة: عسكرية واقتصادية وآيديولوجية (ص 366)”.
يمكن اعتبار كتاب “هزيمة الغرب” من أهم أعمال تود، وعلى الرغم من أنه لم يترجم بعدُ ولو إلى اللغة الإنجليزية فإنه أثار الكثير من الجدل في العالم الغربي، وتناولته الصحف والمنصات المختلفة من الولايات المتحدة الأميركية إلى شرق أوروبا. والسبب ليس فقط أن تنبؤات تود تحققت بالفعل في السابق، ولكن أيضاً لتوقيت الكتاب، فبينما يحارب الغرب في أوكرانيا، ويساند إسرائيل في حربها الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، يأتي تود ويقول للغربيين إنهم في طريقهم إلى الهزيمة، ويبين لهم من خلال مؤشرات متعددة وبيانات هائلة أنهم على شفا الانهيار. ويقول تود إنه حاول في هذا الكتاب أن يتحرر تماماً من الخوف من الأحكام الأخلاقية وأن يقرأ المشهد بشكل علمي غير مؤدلج.
لنعطِ الإيرانيين قنبلة نووية كي يعمّ السلام
من المهم هنا أن نلقي نظرة واسعة على آراء تود التي شكلت منظاره المستقل المثير للجدل في العالم، وعلى إحدى الأفكار الهامة التي شكلت فرادته، وهي نظرته إلى ملفات السياسة الدولية بعيدًا عن الرواية الغربية الكلية. على سبيل المثال، نبه إيمانويل تود منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن ظلم الغرب للفلسطينيين وتجاهله لمحنتهم لا بد أن يتم تقويمه، وأنه لا يمكن أن يعيش الغرب على ذكريات الحرب العالمية الثانية ألف عام، فهذا العيش على الذكرى هو ما يجعل الغرب متعاميًا عن الظلم الواقع على الفلسطينيين، ويجعله مسانداً لجيش الاحتلال على طول الخط. هذه الرؤية للملف الفلسطيني لم ولن تمكن أوروبا – بحسب وجهة نظر تود – من أن تصبح لها كلمة ذات وزن لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كذلك يصل تود إلى درجة القول بأن إيران ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويّاً، لأن هذا هو الحل الوحيد لكي يسود السلام في المنطقة ويتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طغيانه. بالنسبة لتود فإن امتلاك الأسلحة النووية بالتساوي هو السبيل الأمثل للسلام، وليس أن تمتلكه بعض الدول فقط، فهو يرى مثلاً أن امتلاك الاتحاد السوفياتي لأسلحة نووية هو ما منع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أسلحتها ضد الأراضي السوفياتية، عكس ما فعلت مع اليابان في الحرب العالمية الثانية، وكذلك إذا امتلكت إيران القنبلة النووية فستتوقف إسرائيل عن القتل والتشريد دون حساب.
وفي الختام، لا يتردد منتقدو تود في الإشارة إلى ماضيه الشيوعي لتفسير تعاطفه مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وبالرغم من أن هؤلاء لا يكلفون أنفسهم عناء تفسير علاقة روسيا اليوم بالشيوعية، فإن هذه التهمة تعني في الغالب استدعاءً لنوع جديد من الماكارثية من أجل محاصرة وجهات النظر غير المتبنية للسردية الأطلسية الرسمية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. وتهدف الهجمات ضد تود إلى عزله، كما تم عزل عدد من المثقفين من قبله بتهم أخرى عدة مثل اللاسامية، وترسيخ وجهة نظر واحدة في وسائل الإعلام والنشر، هي وجهة النظر الرسمية. بإلقاء نفسها إلى جانب الولايات المتحدة في النزاع الروسي الأوكراني، وتورطها بلا حساب في تسليح الأوكرانيين مبكراً بالمدافع والذخائر والمدرعات، وذلك باعتبار الدعاية إحداها.